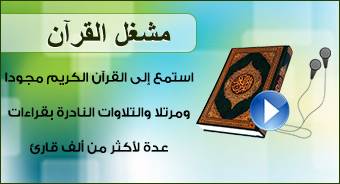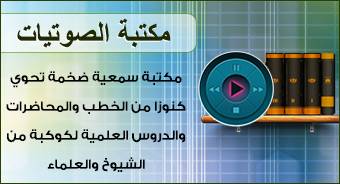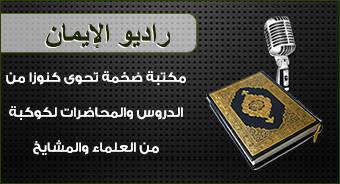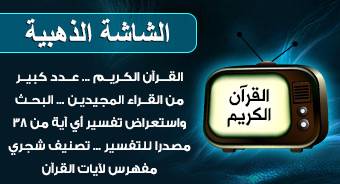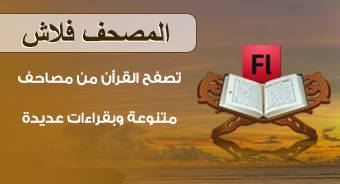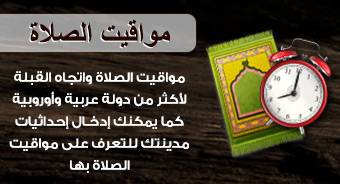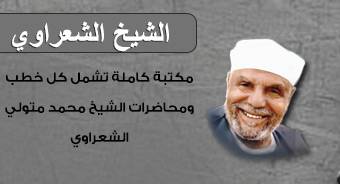|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم مقاييس اللغة ***
(غدر) الغين والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على تَرك الشيء. من ذلك الغَدْر: نَقْضُ العَهْد وتَرْك الوفاءِ به. يقال غَدَر يَغْدِرُ غَدْراً. ويقولون في الذَّمِّ: يا غُدَرُ، وفي الجمع: يالَغُدَرَ. ويقال: ليلةٌ غَدِرَةٌ: بيِّنَة الغَدَر، أي مُظْلمة. وقيل لها ذلك لأنّها تُغَادِرُ النَّاسَ في بيوتهم فلا يَخْرُجُون من شدَّة ظُلْمتها. والغَدير: مُستنقَع ماء المطر، وسمِّي بذلك لأنّ السَّيل غادَرَه، أي ترَكَه. ومن الباب: غَدِرَتِ الشَّاة، إذا تخلَّفَتْ عن الغَنم. فإِنْ تَرَكها الرَّاعي فهي غَدِيرة. والغَدَر: الموضِع الظَّلِفُ الكثير الحِجارة. وسمِّي بذلك لأنَّه لا يكاد يُسْلَك، فهو قد غودر، أي تُرِك. ويقال: رجل ثَبْتُ الغَدَر، أي ثابتٌ في كلامٍ وقتال. هذا مشتقٌ من الكلمة التي قبله، أي إنّه لا يبالي أن يسلُكَ الموضعَ الصَّعبَ الذي غَادَرَهُ الناسُ من صُعوبته. والغَدائر: عقائصُ الشَّعر، لأنَّها تُعْقَص وتُغْدَر، أي تُتْرَك كذلك زماناً. قال: غدائرُهُ مستَشْزِرَاتٌ إلى العُلى *** تَضِلُّ العِقَاصُ في مُثَنَّىً وَمُرْسَلِ (غدن) الغين والدال والنون أُصَيْلٌ صحيح يدلُّ على لِينٍ واسترسال وفَتْرَة. من ذلك المُغْدَوْدِن: الشَّعَْر الطَّويل الناعم المسترسل. قال حسان: وقامت تُرائيكَ مُغْدَوْدناً *** إذا ما تنوءُ به آدَها والشَّبابُ الغُدَانيُّ: الغَضُّ. قال: * بعد غُدَانيِّ الشَّبَاب الأبْلَهِ * وأصلُ ذلك كله من الغَدَن، وهو الاسترخاء والفَتْرَة. (غدف) الغين والدال والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على سَتْرٍ وتغطية. يقال: أغدَفَتِ المرأة قِناعَها: أرسلَتْه. قال: إن تُغْدِفي دوني القِناعَ فإنَّني *** طَبٌّ بأَخْذِ الفارِس المستلئِمِ وأغْدَف اللَّيْلُ: أرْخَى سُدولَه. وأمّا الغُراب الضَّخم فإنَّه يُسمَّى غُدافاً، وهذا تشبيه بإغداف اللَّيل: إظْلامِه. (غدق) الغين والدال والقاف أصلٌ صحيح يدلُّ على غُزْر وكثرةٍ ونَعْمَة. من ذلك الغَدَق، وهو الغَزير الكثير. قال الله تعالى: {لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً} [الجن 16]. والغَدَق والغَيْدَاق: النَّاعم من كلِّ شيء. ويقال غَدِقت عين الماء تَغْدَق غَدَقاً. والغَيْداق: الرَّجلُ الكريم الخُلُق. وزعَم ناسٌ أنَّ الضبَّ يسمَّى غَيداقاً، ولعلّ ذلك لا يكون إِلاَّ لسِمَن ونَعْمةٍ فيه. (غدو) الغين والدال والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ على زمانٍ. من ذلك الغُدُوّ، يقال غدا يغدو. والغُدْوة والغَدَاة، وجمع الغُدوة غُدَىً، وجمع الغَداة غَدَوات. والغادية: سحابةٌ تنشَأ صَباحاً. وأفعلُ ذلك غداً. والأصل غَدْواً. قال: * بها حيث حَلُّوها وغَدْواً بَلاقِعُ * والغَدَاء: الطّعام بعينه، سمِّي بذلك لأنَّه يؤكَل في ذلك الزمان.
(غذم) الغين والذال والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على جنسٍ من الأكل والشُّرب. من ذلك: الغَذْم: الأكل بجفاء وشِدّة. ويقال: اغتَذَم الفصيل ما في ضَرْع أُمِّه، [إذا شرِبَه] كُلَّه. (غذي) الغين والذال والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح* يدلُّ على شيء من المأكل، وعلى جنسٍ من الحركة. فأمَّا المأكل فالغِذَاء، وهو الطَّعام والشَّراب. وغَذِيُّ المالِ وغَذَوِيُّه: صِغاره، كالسِّخال ونحوها. وسمِّي غَذَوِيَّاً لأنه يُغْذَى. وأمَّا الآخر فالغَذَوانُ: النَّشيط من الخَيل، سمِّي لشبابه وحركته. ويقال غَذَّى البَعيرُ ببوله يُغَذِّي، إذا رَمَى به متقطِّعاً. وغَذَا العِرْق يغذو، أي يَسيل دماً. قال: غذَا والزِّقُّ ملآنُ *** وطَعنٍ كفم الزّقِّ
(غرز) الغين والراء والزاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على رَزِّ الشَّيء في الشيء. من ذلك غَرَزْتُ الشَّيءَ أغرِزُه غَرْزاً. وغَرَزْتُ رِجله في الغَرْز. وغَرَزَت الجرادةُ بذَنَبِها في الأرض، مثل رَزّت. والطَّبيعة غريزة، كأنَّها شيء غُرِز في الإنسان. فأمَّا قولهم: اغترَزْت الشَّيءَ، واغترَزْت السَّيرَ اغترازاً، إذا دَنَا سيرك فمعناه تقريبُ السَّير، أي كأنِّي الآنَ وضعتُ رِجلي في غَرْز الرَّحْل. وأمَّا قولهم: غَرَزَت النَّاقةُ، إذا قلَّ لبنُها فمعناه من هذا أيضاً، كأنَّ لبَنَها غُرِزَ في جسمها فلم يَخْرُجْ. (غرس) الغين والراء والسين أصلٌ صحيحٌ قريبٌ من الذي قبله. يقال: غَرَسْتُ الشَّجرَ غَرْساً، وهذا زَمَنُ الغِراس. ويقال إنَّ الغَرِيسة: النَّخْلةُ أوّلَ ما تَنبت. ومما شذَّ عن هذا الغِرْس: جِلدةٌ رقيقة تخرجُ على رأس الوَلَد. قال: * كُلَّ جنينٍ مُشْعَرٍ في غِرْسِ * (غرض) الغين والراء والضاد من الأبواب التي لم تُوضَع على قياسٍ واحد، وكَلِمُه متباينةُ الأصول، وستَرى بُعْد ما بينهما. فالغَرْض والغُرْضَة: البِطانُ، وهو حِزام الرَّحْل. والمَغْرِض من البعير كالمَحْزِم من الدابَّة. والإغريض: البَرَد، ويقال بل هو الطَّلع. ولحمٌ غَريض: طريٌّ. وماءٌ مغروضٌ مثلُه. والغَرَض: المَلاَلة، يقال غَرِضْت به ومنه. والغَرَض: الشَّوق. قال: مَن ذا رسولٌ ناصحٌ فمبلِّغٌ *** عنِّي عُلَيَّةَ غيرَ قِيل الكاذِب أنِّي غَرِضْتُ إلى تَنَاصُفِ وجهِها *** غَرَضَ المحبِّ إلى الحبيب الغائبِ ويقال: غَرَضت المرأة سِقاءها: مَخَضته. وغَرَضْنا السَّخْلَ نَغرِضهُ، إذا فَطَمْناه قبل إناه. والغَرْض: النُّقصان عن المِلْء. يقال: غَرِّضْ في سقائك، أي لا تملأه. ويقال: وَرَدَ الماءَ غارِضاً، أي مبكراً. والمَغَارض: جوانب البطن أسفَلَ الأضلاع، الواحد مَغْرِض. (غرف) الغين والراء والفاء أصلٌ صحيحٌ، إلاَّ نَّ كَلِمهُ لا تنقاس، بل تتباين، فالغَرْف: مصدر غَرَفْت الماءَ وغيرَه أَغرِفُه غَرْفاً. والغُرفة: اسمُ ما يُغْرَف. والغَرِيف: الأجَمَة، والجمع غُرُف. قال: * كما رَزَمَ العَيّار في الغُرُفِ * والغُرْفة: العُِلِّيَّة. ويقال: غَرَفَ ناصيةَ فرسِهِ، إذا استأصلها جَزّاً. (غرق) الغين والراء والقاف أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على انتهاءٍ في شيء يبلغ أقصاه. من ذلك الغَرَق في الماء. والغَرِقة: أرضٌ تكون في غاية الرِّيّ. واغْرَوْرَقت العينُ والأرض من ذلك أيضاً، كأنها قد غَرِقت في دمعها. ومن الباب: أغرَقْتُ في القَوس: [مدَدتُها] غايةَ المدّ. واغْتَرَق الفرسُ في الخيل، إذا خالَطَها ثم سَبَقَها. ومما شذَّ عن هذا الباب الغُرْقة من اللَّبن: قدر ثُلث الإناء، والجمع غُرَق. قال: تُضْحِي وقد ضمِنت ضَرَّاتها غُرَقاً *** من طيِّب الطَّعم حلوٍ غير مجهودِ
(غرل) الغين والراء واللام كلمةٌ واحدة، وهي الغُرْلة، وهي القُلْفَة. والأغرل: الأقْلَف، ويقولون: إنَّ الغَرِل: المسترخِي الخَلْق. (غرم) الغين والراء والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على ملازَمة ومُلازَّة. من ذلك الغَريم، سمِّي غريماً للُزومه وإلحاحه. والغَرَام: العذاب اللازم، في قوله تعالى: {إنَّ عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً} [الفرقان 65]. قال الأعشى: إنْ يعاقِبْ يكنْ غَراماً وإن يُعْـ *** طِ جزيلاً فإنَّه لا يُبالِي وغُرْم المالِ من هذا أيضاً، سمِّي لأنَّه مالُ الغَرِيم. (غرن) الغين والراء والنون كلمةٌ واحدة، يقولون إنَّ الغَرِين: ما يَبقى في الحوض من مائه* وطِينِه. (غرو) الغين والراء والحرف المعتل أصلٌ صحيح، وهو يدلُّ على الإعجاب والعَجَبِ لحُسْن الشَّيء. من ذلك الغَرِيُّ، وهو الحَسَن. يقال منه رجلٌ غَرٍ. ثمَّ سمِّي العَجَبُ غَرْواً. ومنه: أغريتُه بالشَّيء الذي تُلصَق به الأشياء. ويقال: غَارَت العينُ بالدَّمع غِراءً، إذا لجَّت في البكاء. وغَرِيَت بالدَّمع. وقال الشَّاعر: إذا قلتُ أسلُو غارَتِ العينُ بالبُكا *** غِراءً ومَدَّتْها مدامعُ حُفَّلُ (غرب) الغين والراء والباء أصلٌ صحيح، وكَلمُهُ غير منقاسةٍ لكنَّها متجانسة، فلذلك كتَبْناه على جهته من غير طلبٍ لقياسه. فالغَرْب: حَدُّ الشّيء. يقال: هذا غَرْبُ السَّيف. ويقولون: كفَفْتُ من غَرْبه، أي أكْلَلْتُ حَدَّه وقولهم: استَغْرَب الرّجُل، إذا بالَغَ في الضَّحِك، ممكنٌ أن يكون من هذا، كأنَّهُ بلغ آخِرَ حدِّ الضَّحِك. والغَرْب: الدَّلو العظيمة. والغَرْبانِ من العين: مُقْدِمُها ومُؤْخِرُها. وغُروب الأسنان: ماؤُها. فأمَّا الغُروب فَمَجارِي العَين. قال: مالَكَ لا تذكُرُ أُمَّ عمرِو *** إلاّ لعينَيْك غَروبٌ تَجْرِي والغَرْب أيضاً بسكون الراء، في قولهم: أتاهُ سَهْمٌ غَرْب، إذا لم يُدْرَ مَن رماه به. وأمّا الغَرَب بفتح الراء، فيقال إنَّ الغَرَبَ: الرَّاوية. والغَرَب: ما انصبَّ من الماء عند البئر فتغيَّرَتْ رائحتهُ. قال ذو الرُّمة: * واسْتُنْشِئَ الغَرَبُ * والغَرْب: شَجَر. ويقولون –والله أعلَمُ بصحّته-: إنَّ الغَرَب: إناءٌ من ذهب أو فِضَّة. ويُنشِدون: فدعْدَعا سُرَّةَ الرَّكيِّ كَما *** دَعْدَعَ ساقِي الأعاجم الغَرَبا والغَرْب: الوَرَم في المأْق، يقال منه غَرِبَت العينُ غَرَباً. والغَرْب: عِرْقٌ يَسقِي ولا يَنقطِع. والغُرْبة: البُعد عن الوطن، يقال: غَرَبَت الدَّار. ومن هذا الباب: غُروب الشَّمس، كأنَّه بُعْدُها عن وجه الأرض. وشَأْوٌ مُغَرَِّبٌ، أي بعيد. قال: أعْهَدَكَ مِن أُولَى الشَّبيبةِ تطلبُ *** على دُبُرٍ هيهاتَ شَأْوٌ مغرَِّبُ ويقولون: "هل من مُغَرِّبةِ خَبَرٍ"، يريدون خبراً أتَى من بُعد. وفي كتاب الخليل: "إذا أمْعَنَت الكلابُ في طلب الصَّيد قيل: غرَّبَت". وفيه نظر. والغارب: أعلى الظَّهر والسَّنام. يقال: أَلْقَى حبلَه على غاربه، إذا خلاَّه. والغُراب معروف. والغُرابانِ: نُقرتانِ عند صَلَوَي العَجُز من الفَرس. والغُرَاب: رأس الفأس. ورِجْل الغُراب: نوعٌ من الصَّرِّ. قال الكميت: * صُرَّ رِجْلَ الغُرابِ * والغِربيب: الأسود، كأنّه مشتقٌّ من لون الغُراب. والمُغْرَب: الأبيض الأشفار من كلِّ شيء. والغَرْبيّ: الفضيخ من البُسْر يُنْبَذ. والغَرْبيُّ: صِبْغٌ أحمر. (غرث) الغين والراء والثاء أصلٌ صحيح يدلُّ على الجُوع. والغَرث: الجوع. ورجلٌ غَرْثانُ. ويستعيرون هذا فيقولون: جاريةٌ غَرْثَى الوِشاح، لأنَّها دقيقةُ الخَصْرِ لا يُملأ وِشاحُها، وكأنَّ وِشاحَها غَرثان. (غرد) الغين والراء والدال كلمتان: إحداهما صوت، والأخرى نبت. فالأولى: غرَّد الطّائر في صوته يُغَرِّد تغريداً. والكلمة الأخرى: الغَرَْد: الكمأة، الواحدة غَرَْدة. والمَغَاريد: نبتٌ، الواحدة مُغْرود، وزعموا أنَّها هي الكمأة أيضاً.
(غزل) الغين والزاء واللام ثلاثُ كلماتٍ متباينات، لا تُقاس منها واحدةٌ بأخرى. فالأُولى: الغَزْل، يقال غَزَلت المرأة غَزْلَها، والخشبة مِغْزَل، والجمع مَغازِل. والثانية: الغَزَل، وهو حديث الفِتْيان والفَتَيات. ويقال: غَزِلَ الكَلْب غَزَلاً، وهو أن يَطلُبَ الغزالَ حتّى إذا أدرَكَه تركه ولَهَا عنه. والثانية: الغزال، وهو معروف، والأنثى غَزَالة، ولعلَّ اسمَ الشَّمسِ مستعارٌ من هذا، فإنَّ الشَّمسَ تسمَّى الغزالةَ ارتفاعَ الضُّحى. (غزو) الغين والزاء والحرف المعتل أصلانِ صحيحان، أحدهما طلب شيء، والآخر في بابِ اللِّقاح. فالأوَّل الغَزْو. *ويقال: غَزَوت أغزو. والغازي: الطَّالِبُ لذلك، والجمع غُزَاة وغَزِيٌّ أيضاً، كما يقال لجماعة الحاجّ حَجيج. والمُغزِيَة: المرأة التي غزا زَوْجها.ويقال في النِّسبة إلى الغَزْو: غَزَوِيّ. والثاني: قولهم: أغْزَت النَّاقةُ، إذا عَسُر لِقاحُها. وقال قومٌ: الأَتَان المُغْزِية: التي يتأخَّر نِتاجُها ثم تُنْتَج. قال الهذليّ: يُرِنُّ على مُغْزِياتِ العِقا *** قِ يَقْرُو بها قَفَراتِ الصِّلالِ (غزد) الغين والزاء والدال ليس يُشْبِه صحيح كلام العرب. وقد زعموا أنَّ الغِزْيد الشديد الصوت، وأن الغِزْيَد: النبات النّاعم. والله أعلم. (غزر) الغين والزاء والراء كلمةٌ واحدة، وهو قولهم: غَزُرت الناقة: كثُر لبنها غُـَزْراً وغَزَارة. وعين غَزيرَةٌ، ومعروفٌ غزير.
(غسل) الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهيرِ الشّيء وتنقِيَته. يقال: غَسَلتُ الشَّيءَ غَسْلاً. والغُسْل الاسم. والغَسُول: ما يُغْسَل به الرَّأس من خِطْميٍّ أو غيره. قال: عليَّ حرامٌ لا يَمَسُّنِيَ الغِسْلُ*** فيا لَيْلَ إنَّ الغِسْلَ ما دُمْتِ أيِّماً ويقال: فحلٌ غُسَلَة، إذا كثُر ضِرابُه ولم يُلْقِح. والغِسْلينُ المذكور في كتاب الله تعالى، يقال إنَّه ما يَنْغسلُ من أبدان الكفّار في النار. (غسا) الغين والسين والحرف المعتلّ حرفٌ واحد، يدلُّ على تناهٍ في كِبَرٍ أو غيره. يقال غَسَا اللَّيلُ وأغْسَى. وشيخ غَاسٍ: طال عمرُه. ورُوِي أنَّ قارئاً قرأ: "وَقَدْ بَلَغْتُ من الكِبَر غُسِيّاً ". (غسر) الغين والسين والراء كلمةٌ إنْ صحّت تدلُّ على اختلاطٍ. يقولون: تغَسَّر الغَزْل، إذا التَبَس. قال ابن دريد: "الغَسَر: ما طرحَتْه الريح في الغَدِير. ثم كثُر حتى قالوا: تغسَّرَ الأمر: اختلط". (غسم) الغيم والسين والميم ليس بشيء. وربَّما قالوا الغَسَم، الظُّلْمة. (غسن) الغين والسين والنون كلمةٌ. يقولون إنَّ الغُسَن: خُصَل الشَّعر. ويقال للناصية: غُسْنة. (غسق) الغين والسين والقاف أصلٌ صحيح يدل على ظُلْمة. فالغَسَق: الظلمة. والغاسِق: الليل. ويقال: غَسَقت عينُه: أظلمت. وأغْسَقَ المؤذِّن، إذا أخَّر صلاةَ المغرب إلى غَسَق اللَّيل. وأمّا الغَسَّاق الذي جاء في القرآن، فقال المفسِّرون: ما تقطَّرَ من جلود أهل النار.
(غشم) الغين والشين والميم أصلٌ واحد يدلُّ على قَهْر وغَلَبة وظُلْم. من ذلك الغَشْم، وهو الظُّلم. والحَرْبُ غشومٌ لأنَّها تنال غيرَ الجاني. والغَشَمْشَم: [الذي] لا يثنيه [شيءٌ] من شجاعته. وزيد في حروفه للزِّيادة في المعنى. (غشي) الغين والشين والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على تغطيةِ شيءٍ بشيء. يقال غَشَّيت الشَّيءَ أُغَشِّيه. والغِشاء: الغِطاء. والغاشِية: القيامة، لأنَّها تَغْشَى الخَلْق بإفزاعها. ويقال: رَمَاه الله بغاشيةٍ، وهو داء يأخذ كأنّه يغشاه. والغِشْيان: غِشْيان الرّجُل المرأة.
(غصن) الغين والصاد والنون كلمة واحدة، وهي غُصْن الشَّجَرة، والجمع غُصُون وأغصان. ويقال: غَصَنت الغُصْن: قَطَعْتُه.
(غضف) الغين والضاد والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على استرخاءٍ وتهدُّم وتغَشٍّ. من ذلك الأغْصَف من السِّباع: ما استرخت أذُنه. ومن الباب: ليلٌ أغضَفُ، أي أسودُ يغشَى بظلامه. قال ذو الرُّمَّة: قد أعسِفُ النَّازحَ المجهولَ مَعْسِفُه *** في ظلِّ أغضَفَ يدعو هامَهُ البومُ ويقولون: عيشٌ غاضِف، أي ناعم، كأنَّه قد غَشِيَ بخيره وغَضَارته. *والغُضْف: القَطا الجُون، وهذا على التَّشبيه بالليل وسَوادِه. ويقال: تغضَّفَت البِئر، إذا تهدَّمت أَجوالُها فغَشِيَتْ ما تحَتَها. ويقال: غَضَفت الأُتن تَغْضِفُ، إذا أخذَتْ الجريَ أخْذاً. وهذا لأنَّها تَغْشَى الأرض بجريها. قال: يَغُضُّ ويَغْضِفْن من ريِّقٍ *** كشُؤبوبِ ذي بَرَدٍ وانسجال (غضن) الغين والضاد والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على تثنٍّ وتكسُّر. من ذلك الغُضُون: مَكاسر الجِلْد، ومَكاسِر كلِّ شيء غُضون. وتغضَّنَ جِلدُه. والمغاضَنَة: مكاسَرة العينين. ومن الباب قولهم: ماغَضَنك عن كذا، أي ما عاقك عنه. وغَضَن العَينِ: جلدُها الظّاهر، سمِّي لتكسُّرٍ فيه. ومما شذَّ عن هذا الباب قولهم: "غَضَنت النّاقةُ بولدها، إذا ألقَتْه قبل أن يُنْبِت. (غضر) الغين والضاد والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على حُسنٍ ونَعْمة ونَضرة. من ذلك الغَضَارة: طيبُ العَيش: ويقولون في الدُّعاء: أبادَ الله تعالى غَضراءهم، أي خَيرهم وغضارتهم. قال عبد الله بن مُسلم: أصل الغَضْراء طِينةٌ خضراءُ عَلِكة. يقال: أَنْبَطَ بئرَه في غَضْراءَ، ويقال: دابّةٌ غَضِرةُ النَّاصية. إذا كانت مباركة. ومن الباب: الغاضر: الجلد الذي أُجِيد دبغُه. ومما شذَّ عن هذا الباب قولُهم: لم يَغْضِرْ عن ذلك، أي لم يَعْدِل عنه. قال ابنُ أحمر: * ولم يَغْضِرْنَ عن ذاك مَغْضَرا * والغَضْوَر: نَبْت. (غضب) الغين والضاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على شدَّة وقُوّة. يقال: إنَّ الغَضْبة: الصَّخرة الصُّلبة. قالوا: ومنه اشتُقَّ الغَضَب، لأنَّه اشتدادُ السُّخط. يقال: غَضِب يَغْضَبُ غَضَباً، وهو غضبانُ وغَضُوب. ويقال: غَضِبْتُ لفلانٍ، إذا كان حيّاً؛ وغضبت به، إذا كان ميّتاً. قال دُرَيد: * أنَّا غِضابٌ بمعبدِ * ويقال: إنَّ الغَضُوب: الحيَّة العظيمة. (غضل) الغين والضاد واللام. يقولون: أَغْضَلَتِ الشَّجرة واغضالَّتْ، إذا كثُرت أغصانها. (غضا) الغين والضاد والحرف المعتلّ كلمتان: فالأولى: الإغضاء: إدناء الجُفون. وهذا مشتقٌّ من اللَّيلة الغاضِية، وهي الشَّديدة الظُّلمة. والكلمة الأخرى: الغَضَا، وهو شجرٌ معروف. يقال: أرضٌ غَضْيَاء: كثيرة الغَضَا. ويقال: إبلٌ غَضِيَةٌ: اشتكَتْ عن أكل الغَضَا.
(غطف) الغين والطاء والفاء أصلٌ صحيح يدلُّ على خَير وسُبوغٍ في شيء، وأصله الغَطَف في الأشفار، وهو كثرتُها وطولُها وانثناؤُها. ثم يقال: عيشٌ أغطَف، إذا كان ناعماً منثَنِياً على صاحبه بالخَير. والمصدر الغَطَف. (غطل) الغين والطاء واللام ثلاث كلمات: الغَيْطَلة: الشَّجَرَةُ، والجمع الغَيْطَل. قال: فظلّ يُرَنِّحُ في غَيطلٍ *** كما يستدير الحِمارُ النّعِرْ والغَيْطلة: البَقَرَة. والغيطلة: التجاج اللَّيلِ وسوادُه. (غطم) الغين والطاء والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على كثرةٍ واجتماع. من ذلك البحر الغِطَمُّ. ويقال لمُعْظَمِ البَحْر. غُطَامِطٌ. ورجلٌ غِطَمٌّ: واسع الخُلُقُ. (غطو) الغين والطاء والحرف المعتل يدلُّ على الغِشاء والسَّتر. يقال: غَطَيت الشَّيءَ وغَطَّيْتُه. والغِطاء: ما تَغَطَّى به. وغَطَا اللّيلُ يَغْطُو، إذا غَشَّى بظلامه. (غطش) الغين والطاء والشين أصلٌ واحدٌ صحيح، يدلُّ على ظُلْمَةٍ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوّله غين وما أشبَهها. من ذلك الأغطش، وهو الذي في عينه شِبْه العَمَش، والمرأة غَطْشاء. وفَلاةٌ غَطْشَى: لا يُهْتَدَى لها. قال: ويَهْماءَ باللَّيلِ غَطْشَى الفلا *** ةِ يؤنِسُني صوتُ فَيَّادِها وغَطَشَ الليلُ: أظلَمَ. والله تعالى أغْطَشَه. والمتغاطِش: المتعامِي عن الشَّيء. ويقال: هو يَتَغَاطش. (غطس) الغين والطاء والسين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على *الغَطِّ. يقال: غطَطْتُه في الماء وغَطَسته. وتَغَاطَسَ القومُ: تغاطُّوا.
من ذلك (الغَطَمَّش): الكليل البَصَر. والغَطَمَّش: الظَّلوم الجائر. وهذا مما زيدت فيه الميم، والأصل الغَطْش وهو الظُّلْمة. والجائر يتغاطَش عن العَدْل، أي يتعامَى. ومن ذلك (الغَشْمَرة): إتْيَانُ الأمرِ من غيرِ تثبُّت، وهذه منحوتةٌ من كلمتين: من الغَشْم والتشمُّر، لأنه يتشمَّر في الأمر غاشماً. ومن ذلك (الغَمَلّج)، وهو ممّا نُحِتَ من كلمتين: من غَمَج وغلَج، وهو البعير الطَّويل العُنق. فأمَّا غَمَجُه فاضطرابُه. يقال: غَمَج، إذا جاء وذهب. والغَلَج كالبَغْي في الإنسانِ وغيره. ومن ذلك (الغُضْرُوف): نَغْض الكَتِف. وهي منحوتةٌ من كلمتين: من غَضَرَ وغَضَف. فأمَّا غَضَرُه فلِينُه، لأنَّه ليس فيه شِدَّة العظم وصلابتُه. وأمَّا غَضَفُه فتثنِّيه، لأنَّه يتثنَّى إذا ثُنِي للينه. ومن ذلك (الغَطْرسة): التكبُّر. وهذا ممَّا زيدت فيه الراء؛ وهو من الغَطس كأنَّه يَغلِبُ الإنسانَ ويقهرُه حتى كأنَّه غَطَسه، أي غطَّسه. ومن ذلك (الغَطْرَفة)، وهي الكِبْر والعظمة. قال في التغطرف: فإِنَّك إنْ أغضبْتَنِي غَضِبَ الحَصَى *** عليك وذُو الجََُبُّورة المتغَطْرِفُ وهذا أيضا مما زيدت فيه الراء، وهو من الغَطَف، وهو أن يَنْثَنِيَ الشيءُ على الشَّيء حتى يغشاه. فالجبّار يقهر الأشياءَ ويُغَشِّيها بعظمته. و(الغِطْريف): السَّيِّد يَغْشى بكرمِهِ وإِحسانه. ومن ذلك (الغَذْمَرَة)، يقال إنَّه رُكوب الأمرِ على غير تثبُّت. وقد يكون في الكلامِ المختلِط. وهذه منحوتةٌ من كلمتين: من غَذَم وذَمَر. أمَّا الغَذْم فقد قلنا إنَّه الأكل بجفاءٍ وشِدَّة. ويقولون: كيلٌ غُذَامِرٌ، إذا كان هَيْلاً كثيراً. وأمَّا الذَّمْر فمن ذَمَرته، إذا أغضبتَه. كأنَّه غَذُوم ذَمَر. ثم نحتت من الكلمتين كلمةٌ. ومن ذلك (الغَضَنْفَر)، وهو الرَّجُل الغليظ، والأسد الغَشُوم. وهذا ممَّا زيدت فيه الراء والنون، وهو من الغَضَف. وقد مضى أنّ اللّيلَ الأغضفَ الذي يُغشِّي بظلامِه. ومن ذلك (المُغَثْمَرُ)، وهو الثَوْب الخشنُ الرَّديءُ النَّسْج. قال: عَمْداً كسوتُ مُرْهِباً مُغَثْمَرَا *** ولو أشاءُ حِكْتُهُ مُحَبَّرَا يقول: ألبستُهُ المغَثَْمَرَ لأدفع به عنه العينَ. وهذه منحوتةٌ من كلمتين: من غَثمَ وغَثَرَ. أمَّا غَثَر فمن الغُثْر، وهو كلُّ شيء دُونٍ. وأمَّا غَثَمَ فمن الأغثم: المختلط السَّواد بالبياض. ومما وُضع وضعاً وليس ببعيدٍ أن يكون لـه قياس (غَرْدَقْتُ) السِّتْرَ: أرسلتُه. و(الغُرْنُوق): الشَّابُّ الجميل. و(الغِرنَِيق) طائر. ويقولون: (الغَلْفَقُ): الطُّحُلَب. ويقولون: (اغْرَندَاهُ)، إذا عَلاَهُ وغَلَبه. قال: قد جعل النُّعاس يَغْرَنْدِينِي *** أدفَعُهُ عني ويَسْرَنْدِينِي (تم كتاب الغين، والله أعلم بالصواب)
(فق) الفاء والقاف في المضاعف يدلُّ على تفتُّح واختلاطٍ في الأمر. يقال: انفَقّ الشَّيءُ، إذا انفرَجَ. ويقولون: رجلٌ فَقْفَاقٌ، أي أحمق مُخلِّطٌ في كلامه. ويقال فَقَاقٌ أيضاً. (فك) الفاء والكاف أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تفتُّح وانفراج. من ذلك فَكَاك الرَّهْن، وهو فَتْحُه من الانغلاق. وحكى الكسائي: الفِكَاك بالكسر. ويقال: فَكَكْتُ الشَّيءَ أفكُّه فكّاً. وسقط فلانٌ وانفكَّت قدمُه، أي انفرجت. وقولهم: لا ينفكُّ يفعل ذلك، بمعنى لا يزال. والمعنى هو وذلك الفعلُ لا يفترقان. فالقياس فيه صحيح. والفكُّ: انفراج المَنْكِبِ عن مَفْصِله ضَعْفا. ومما هو من الباب: الفَكَّانِ: مُلتقى الشِّدْقين. *وسمِّيا بذلك للانفراج. (فل) الفاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على انكسارٍ وانثلام. أو ما يقاربُ ذلك. مِن ذلك الفَلُّ: القومُ المنهزِمون. والفُلولُ: الكُسور في حدِّ السيف، الواحدُ فَلٌّ. قال النابغة: ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سُيوفَهم *** بهنَّ فُلولٌ من قِراع الكتائبِ والفليل: ناب البعير إذا انثلَمَ. ومما يقارب هذا الفِلُّ: الأرض لا نباتَ فيها. والقياس فيه صحيح. وقال: * فَِلٌّ عن الخير مَعْزِلُ * يقال: أفلَلْنا: صِرنا في الفَِلّ. ومما شذّ عن هذا الأصل: الفَليلة: الشّعر المجتمِع، والجمع الفليل. قال: ومُطَّرِدِ الدِّماءِ وحيث يُهْدَى *** من الشَّعَر المضفّر كالفليلِ (فم) الفاء والميم ليس فيه غير الفم، وليس هذا موضعه، لكن حكي فمٌّ بالضمّ والتشديد. قال: * يا ليتها قد خرجَتْ من فُمِّهْ * (فن) الفاء والنون أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما على تعنِيَةٍ، والآخَر على ضربٍ من الضُّروب في الأشياء كلِّها. فالأوّل: الفَنّ، وهو التعنية والإطراد الشّديد. يقال: فَنَنْتُه فَنّاً، إذا أطردتَه وعنّيْتَه. والآخر الأفانين: أجناس الشّيء وطُرقُه. ومنه الفَنَن، وهو الغصن، وجمعه أفنان، ويقال: شجرةٌ فَنْواء، قال أبو عبيد: كأنّ تقديره فَنّاء. (فه) الفاء والهاء كلمةٌ واحدةٌ تدل على العِيِّ وما أشبهه، من ذلك الرّجل الفَهُّ، وهو العَيِيّ، والمرأة فَهّةٌ، ومصدره الفَهَاهة. قال: فلم تَلقَنِي فَهَّاً ولم تَلْقَ حُجَّتي *** مُلَجْلَجَةً أبغِي لها مَنْ يقيمُها ويقال: خرجتُ لحاجةٍ فأَفَهَّنِي فلانٌ حتَّى فَهِهْت، أي أنسانِيها. (فأ) الفاء والهمزة مع معتلٍّ بينهما، كلماتٌ تدلُّ على الرجوع. يقال: فاء الفَيء، إذا رجع الظِّلُّ من جانب المغرِب إلى جانب المشرق. وكلُّ رجوعٍ فيءٌ. قال الله تعالى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} [الحجرات 9]، أي ترجع. قال الشَّاعر: تَيَمَّمَتِ العَينَ التي عند ضارجٍ *** يَفيءُ عليها الظِّلُّ عِرْمِضُها طامِ يقال منه: فيَّأَتِ الشَّجرةُ، وتَفَيّأْت أنا في فَيئها. والمرأة تَفيِّئُ شعرَها، إذا حرَّكتْ رأسَها من قِبَل الخُيَلاء. ويقال تفيُّؤها: تكسُّرها لزَوْجِها. والقياس فيه كلِّه واحد. والفيء: غنائمُ تُؤخذ من المشركين أفاءها الله تعالى عليهم. قال الله سبحانه: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى} [الحشر 7]. ويقال: استفأْتُ هذا المالَ، أي أخذتُه فيْئاً. وفلانٌ سريع الفَيءِ من غضبه والفِيئَة. فأمَّا قولهم: يا فَيْءَ مالِي، فيقولون: إِنَّها كلمةُ أسفٍ. وهذا عندي من الكلام الذي ذهب مَنْ كان يُحسن حقيقةَ معناه. وأنشد: يا فَيْءَ مالِي مَنْ يُعَمَّرْ يُفْنِهِ *** مرُّ الزَّمان عليه والتَّقليبُ (فت) الفاء والتاء كلمةٌ تدلُّ على تكسير شيء ورفْتِه. يقال: فَتَتُّ الشَّيءَ أفُتُّ فَتَّاً، فهو مفتوتٌ وفَتيت. وفُتَّة: ما يُفَتُّ ويُوضَع تحتَ الزَّند. وفَتَّ في عضُده، وذلك إذا أساء إليه، كأنَّه قد فَتَّ من عَضُده شيئاً. ومما شذَّ عن هذا الأصل الفَتفتة: أن تشرب الإبلُ دونَ الرِّيّ. (فث) الفاء والثاء كلماتٌ تدلُّ على كَسْر شيءٍ، أو نثرِه، أو قلعه. من ذلك قولهم: فَثَّ جُلَّته: نَثَرها. وانفَثَّ الرّجُلُ من همٍّ أصابه، أي انكسر. ويقال إنّ الفَثَّ: الفسيلُ يُقتلَعُ من أصله. ومن الباب الفَثُّ، وهو هَبِيدُ الحَنظل، لأنّه يُنثَر. (فج) الفاء والجيم أصلٌ صحيح يدلُّ على تفتُّح وانفراج. من ذلك الفَجُّ: الطَّريق الواسع. ويقال: قَوسٌ فَجّاءُ، إذا بَانَ وترُها عن كَبِدها. والفَجَج أقْبَحُ من الفَحَج. ومنه حافرٌ مُفِجٌّ، أي مقبَّب، وإذا كان كذا كان في باطنه شِبْه الفَجْوة. ومما شذَّ عن هذا الأصل: الفِجُّ: الشيء لم ينضَجْ مما ينبغي نُضْجُه. وشذّت كلمةٌ واحدة أخرى حكاها ابنُ الأعرابيّ، قال: أَفَجَّ يُفِجُّ، إذا أسرع. ومنه رجلٌ فجفاجٌ: كثير الكلام. (فح) الفاء والحاء كلمةٌ واحدةٌ، وهو* الفَحيح: صوتُ الأفعى. قال: كأَنَّ نَقيقَ الحَبِّ في حاويائِهِ *** فَحِيحُ الأفاعي أو نقيقُ العقاربِ (فخ) الفاء والخاء كلماتٌ لا تنقاس. من [ذلك] الفَخِيخ كالغَطيط في النَّوم. والفَخَّة: استرخاءٌ في الرجلين. ويقال الفَخَّة: المرأة الضخمة. والفَخُّ للصَّيد معروف. (فد) الفاء والدال أصلٌ صحيح، يدلُّ على صَوت وجَلَبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الجفاءَ والقَسْوةَ في الفَدَّادِين "، وهي أصواتُهم في حروثِهم وموَاشيهم. قال الشَّاعر: نُبِّئْتُ أخوالِي بني يزيدُ *** ظلماً علينا لهُمُ فَدِيدُ ومما شذَّ عن هذا: الفَدْفَد: الأرض المستويَة. (فذ) الفاء والذال كلمةٌ واحدة تدلُّ على انفرادٍ وتفرُّق. من ذلك الفَذُّ، وهو الفَرْد. ويقال: شاةٌ مُفِذٌّ، إذا ولدت واحداً، فإن كان ذلك عادتَها فهي مِفْذَاذ. ولا يقال: ناقةٌ مُفِذّ، لأنَّ الناقة لا تلِدُ إلاَّ واحداً. ويقال تَمْرٌ فَذٌّ: متفرِّق. والفَذُّ: الأوَّل من سِهام القِداح. (فر) الفاء والراء أصول ثلاثة: فالأوّل الانكشاف وما يقاربُهُ من الكَشْف عن الشَّيء، والثاني جنسٌ من الحيوان، والثالث دالٌّ على خِفّة وطَيْش. فالأوّل قولهم: فَرّ عن أسنانه. وافتَرَّ الإنسان، إذا تبسَّمَ. قال: يفترُّ مِنْك عن الواضحا *** تِ إذْ غيرُك القَلِح الأثْعَلُ ويقولون في الأمثال: * هو الجوادُ عينُه فُِرارُه * أي يَغنيك مَنظرُه من مَخْبَره. وكأَنَّ معنَى هذا إنَّ نَظَرَك إليه يُغنيك عن أن تَفُرَّه، أي تكشفَه وتبحثَ عن أسْنانِه. ويقولون: أفرَّ المُهرُ، إذا دنا أن يُفَرَّ جَذَعاً. وأفَرَّت الإبلُ للإثناء إفراراً، إذا ذهبَتْ رَواضِعُها وأَثْنَتْ. ويقولون: فُرَّ فلاناً عمَّا في نفسه، أي فتِّشْه. وفُرَّ عن الأمر: ابحثْ. ومن هذا القياس وإن كانا متباعدَين في المعنى: الفِرار، وهو الانكشاف، يقال فَرَّ يَفِرّ، والمَفَرّ المصدر. والمَفَرّ: الموضع يُفَرُّ إليه. والفرّ: القَوم الفارُّون. يقال فَرٌّ جمع فارّ، كما يقال صَحْبٌ جمع صاحب، وشَرْبٌ جمع شارب. والأصل الثاني: الفَرير: ولد البقرة. ويقال الفُرَار من ولد المَعْز: ما صَغُر جسمُه، واحدة فَرِيرٌ، كرَخْل ورُخال، وظئر وظُؤار. والثالث: الفَرْفَرة: الطَّيْش والخِفَّة. يقال: رجلٌ فَرْفارٌ وامرأةٌ فرفارة. والفَرفارة: شجرة. (فز) الفاء والزاء أُصَيلٌ يدلُّ على خفّةٍ وما قاربَهَا. تقول: فَزَّهُ واستفزَّه، إذا استخفَّه. قال الله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْض} [الإسراء 76]، أي يحملونك على أن تَخِفَّ عنها. وأفزَّه الخوفُ وأفْزَعَه بمعنىً. وقد استفَزَّ فُلاناً جهْلُه. ورجل فَزٌّ: خفيف. ويقولون: فزَّ عن الشيء: عدل. والفَزُّ: ولَد البقرة. ويُمكن أن يسمَّى بذلك لخفَّة جسمِه. قال: كما استغَاثَ بسيءٍ فَزُّ غَيْطَلَةٍ *** خافَ العُيونَ ولم يُنظُرَ به الحَشَكُ (فس) الفاء والسين ليس فيه شيءٌ إلا كلمةٌ معرّبة. يقولون الفِسْفِسَةُ: الرَّطْبَةُ. (فش) الفاء والشين يدلُّ على انتشارٍ وقلّة تماسُك. يقال: ناقةٌ فَشُوشٌ، إذا كانت مُنتشرَةَ الشَّخْب. وانْفَشَّ عن الأمر: كسِلَ. والفَشُّ: تتبُّع السَّرَقِ الدُّون؛ وهو فَشَّاش. (فص) الفاء والصاد كلمةٌ تدلُّ على فَصْل بين شيئين. من ذلك الفُصُوصُ، هي مفاصِلُ العظامِ كلِّها –قال أبو عبيد: إِلاّ الأصابع- واحدها فَصّ. ومن هذا الباب: أفْصَصت إليه من حقِّه شيئاً، كأنَّكَ فصَلْتَه عنك إليك. وفَصَّ الجُرْحُ: سال. ومما يقارِبُ هذا: الفَصُّ: فَصُّ الخاتَم. وسمِّي بذلك لأنَّه ليس من نَفس الخاتَم، بل هو مُلْصَقٌ به. فأمَّا فَصُّ العَينِ فحدَقتُها على معنى التَّشْبيه. (فض) الفاء والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تفريقٍ وتجزئة. من ذلك: فضَضْتُ الشَّيءَ، إذا فرَّقتَه؛ وانْفَضَّ هو. وانْفَضَّ القومُ: تفرَّقوا. قال الله سبحانه:{وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران 159]. ومن هذا الباب: فَضَضْت عن الكِتاب خَتْمَه. وممكن أن *يكون الفِضَّةُ من هذا الباب، كأنها تفضّ، لما يتَّخَذُ منها من حَلْي. والفُِضاض: ما تفضَّضَ من الشيء إذا انفَضَّ. والفاضَّة: الدّاهية، والجمع فَوَاضُّ، كأنَّهَا تَفُضُّ، أي تُفَرَّق.ومن الذي يجوز أن يُقاسَ على هذا: الفَضْفَضَة: سَعَةُ الثَّوب. وثوبٌ فَضفاضٌ ودرعٌ فضفاضةٌ، لأنَّها إذا اتسَعتْ تباعَدَتْ أطرافُها. وأمَّا الفضِيض فالماءُ العَذْب، سمِّي لفَضاضتِه وسُهولةِ مَرِّه في الحَلْقِ. (فظ) الفاء والظاء كلمةٌ تدلُّ على كراهةٍ وتكرُّه. من ذلك الفَظ: ماءُ الكَرِش. وافتُظَّ الكرِش، إذا اعتُصِر. قال الشاعر: فكانوا كأنفِ اللَّيث لا شَمَّ مَرْغَماً *** وما نال فَظَّ الصَّيد حَتَّى يُعفِّرا قال بعضُ أهل اللُّغة: إِنَّ الفَظاظةَ من هذا. يقال رجلٌ فظٌّ: كريه الخُلُق. وهو من فَظِّ الكَرِش، لأنه لا يُتناول إِلاَّ ضرورةً على كراهة. ويقولون: الفَظِيظ: ماءُ الفَحْل. (فغ) الفاء والغين ليس فيه كلامٌ أَصيل، وهو شِبْهُ حكايةٍ لصوت. يقولون: الفَغْفَغَة: الصَّوت بالغَنَم. ويقولون: الفغْفغاني: القصَّاب أو الرَّاعي؛ وكذلك الفَغْفغيّ. ويقول: الفَغْفَغان: الرّجلُ الخفيفُ. وتفغفغَ في أمره: أسرَعَ. وكلُّ هذا قريبٌ بعضه من بعض. والله أعلم بالصَّواب.
(فقم) الفاء والقاف والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اعوجاج وقلة استقامة. من ذلك الأمْرُ الأفْقَمُ، هو الأعوج. والفَقَم: أن تتقدَّمَ الثَّنايا السُّفلى فلا تقَعَ عليها العُليا. وهذا هو أصل الباب: وزعم أبو بكر: أنَّ الفَقَم الامتلاء. يقال: أصاب من الماء حَتَّى فَقِمَ، هو أصل الباب. فإن كان هذا صحيحاً فهو أيضاً من قياسه. (فقه) الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به. تقول: فَقِهْتُ الحديث أفْقَهُه. وكلُّ عِلْمٍ بشيءٍ فهو فِقْه. يقولون: لا يَفْقَه ولا يَنْقَه. ثم اختُصَّ بذلك علمُ الشّريعة، فقيل لكلِّ عالم بالحلال والحرام: فقيه. وأَفْقَهْتُك الشَّيءَ، إذا بَيّنْتُه لك. (فقأ) الفاء والقاف والهمزة يدلُّ على فَتْح الشيء، وتفتُّحه. يقال: تفقَّأت السَّحابةُ عن مائها، إذا أرسلَتْه، كأنَّها تفتحت عنه. ومن ذلك: الفَقْء، وهي السَّابِياءُ الذي ينفرج عن رأس المولود. ومنه فَقَأْتُ عينَه أفقؤها. فأما الفُقَى مليَّنٌ فجمع فُوقٍ، وهو مقلوبٌ وليس من هذا الباب. قال: ونَبْلِي وفُقاهَا كـ *** ـعَراقيبِ قَطاً طُحْلِ (فقح) الفاء والقاف والحاء يدلُّ على مِثْلِ ما ذكرناه قبلَه من التفتُّح. من ذلك الفُقَّاحُ: نور الإذْخِر، سمِّي بذلك لتفتُّحه، ويقال بل نور الشّجرِ كلُّه فُقَّاح. ويقال: فَقَّح الجَروُ: فتّح عينَيه. قال الشَّاعر: وأكحُلْكَ بالصَّابِ أَو بالجَلاَ *** فَفَقِّحْ لذلك أو غمِّضِ (فقد) الفاء والقاف والدال أصيل يدلُّ على ذَهاب شيء وضَياعِه. من ذلك قولهم. فَقَدت الشَّيء فَقْداً. والفاقد: المرأة تَفْقِد ولدَها أو بعلها، والجمع فَواقِد. فأمَّا قولُك: تفقَّدْتُ الشَّيءَ، إذا تطلّبتَه، فهو من هذا أيضاً، لأنَّك تطلبه عند فقدك إيَّاه. قال الله تعالى: {وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لا أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الغَائِبِينَ} [النمل 20]. (فقر) الفاء والقاف والراء أَصلٌ صحيح يدلُّ على انفراجٍ في شيء، من عضوٍ أو غير ذلك. من ذلك: الفَقَار للظَّهر، الواحدة فَقَارةٌ، سمِّيت للحُزُوز والفُصول التي بينها. والفقير: المكسور فَقَارِ الظَّهر. وقال أهل اللُّغة: منه اشتُقَّ اسمُ الفقير، وكأنه مكسورُ فَقَار الظَّهر، من ذِلَّتِهِ ومَسْكَنتِه. ومن ذلك: فقْرَتْهم الفاقرة، وهي الدَّاهية، كأنها كاسرةٌ لفَقار الظهر. وبعضُ أهلِ العلم يقولون: الفَقير: الذي له بُلْغَةٌ من عَيْشٍ* ويحتجُّ بقوله: أمَّا الفَقير الذي كانت حَلُوبَتُه *** وَفْقَ العِيال فلم يُترَك له سَبَدُ قال: فجعل لـه حَلوبةً، وجعَلَها وَفْقاً لعياله، أي قوتاً لا فَضْلَ فيه. وأمَّا الفقير فإنَّه مَخرَج الماءِ من القناة، وقياسُه صحيح، لأنّه هُزِم في الأرض وكُسِر. وأمَّا قولهم: أفْقَرَكَ الصَّيدُ، فمعناه أنَّه أمكَنَك من فَقَارِه حتَّى ترمِيَه. ويقال: فَقَرْتُ البعيرَ، إذا حَزَزتَ خَطمَه ثم جعلتَ على موضع الحزِّ الجَرِيرَ لتُذِلَّه وتَرُوضَه. وأفْقَرتُكَ ناقتي: أعَرْتُك فَقَارَها لتركبَها. وقول القائل: * مَا ليلةُ الفَقير إِلاَّ شَيطانْ * فالفقير ها هنا: رَكيٌّ معروف. ويقال: فَقَرت للفَسِيل، إذا حفَرْتَ له حينَ تغرسه، وفَقَرت الخَرَزَ، إذا ثقبتَه. وسَدَّ اللهُ مَفاقِره، أي أغناه وسَدَّ وجوهَ فقره. قال: وإِنَّ الذي ساقَ الغنَى لابنِ عامرٍ *** لَرَبِّي الذي أرجو لسدِّ مَفاقرِي (فقس) الفاء والقاف والسين. يقولون: فَقسَ: مات. (فقص) الفاء والقاف والصاد ليس بشيء، إلا أنَّهم يقولون: فُقِصَت البيضةُ عن الفَرْخ. (فقع) الفاء والقاف والعين. اعلمْ أنَّ هذا البابَ وكلِمَهُ غيرُ موضوعٍ على قياس، وهي كلماتٌ متبايِنة. من ذلك الفَقْع: ضَربٌ من الكَمأَة، وبه يشبَّه الرّجلُ الذَّليل فيقال: "هُوَ أذَلُّ من فَقْعٍ بقاع ". والفَقْع: الحُصَاص. وهذا من قولهم: فَقَّع بأصابعه: صَوَّت. وممّا لا يشبه الذي قبلَه صفةُ الأصفر، يقال أصفرُ فاقع. ويقولون: الإفقاع. سُوء الحال، يقال منه: أفْقَعَ. وفَواقع الدَّهر: بَوائِقُه فأمَّا الفُقَّاع فيقال إنّه عربيّ. قال الخليل: سمِّي فُقّاعاً لما يرتفع في رأسه من الزَّبد. قال: والفَقاقيع كالقوارير فوق الماء.
(فكل) الفاء والكاف واللام كلمةٌ واحدة، وهي الأفْكَل: الرِّعدة. ويقولون: لا يُبنَى منه فعل. (فكن) الفاء والكاف والنون كلمةٌ واحدة، وهي التندّم، يقال تندّم وتفكَّنَ بمعنىً. (فكه) الفاء والكاف والهاء أصلٌ صحيح يدلُّ على طِيب واستطابةٍ. من ذلك الرّجُل الفَكِه: الطيِّب النَّفس. ومن الباب: الفاكهة، لأنَّها تُستَطابُ وتُستطرَف. ومن الباب: المُفاكهَة، وهي المُزاحة وما يُستحلَى من كلام. ومن الباب: أفكَهَتِ النّاقةُ والشّاةُ، إذا دَرَّتا عند أكل الرَّبيع وكان في اللبن أدْنَى خُثُورة؛ وهو أطيَبُ اللَّبن. فأمَّا التَّفَكُّه في قوله تعالى: {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} [الواقعة 65]، فليس من هذا، وهو من باب الإبدال، والأصل تَفَكَّنون، وهو من التندُّم، وقد مضى ذِكرُه. (فكر) الفاء والكاف والراء تردُّدُ القَلْب في الشَّيء. يقال تفكّرَ إذا ردَّدَ قلبه معتبِرا. ورجلٌ فِكِّير: كثير الفِكر.
(فلم) الفاء واللام والميم كلمةٌ. يقولون الفَيْلم: العظيم من الرِّجال. وفي ذكر الدَّجَّال: "رأيتُه فَيْلَمَانِيَّاً". وقال الشَّاعر: ويَحمِي المُضافَ إذا ما دَعا *** إذا فرَّ ذُو اللِّمَّةِ الفَيْلَمُ ويقولون: الفَيْلَم: المُشْط. وليس بشيء. (فلن) الفاء واللام والنون كناية عن كلِّ أحد. ورخَّمه أبو النجمِ فقال: * في لَجَّةٍ أَمْسِكْ فُلانَاً عَنْ فُلِ * هذا في الناس، فإنْ كان في غيرهم قيل: ركبتُ الفلانةَ والفرس الفلان. (فلو) الفاء واللام والحرف المعتلّ كلمةٌ صحيحة فيها ثلاث كلمات: التّربية، والتفتيش، والأرض الخالية. فالتّربِيَة: فَلَوتُ المُهْرَ، إذا ربَّيْته. يقال: فلاهُ يَفلوه. ويسمَّى فَلُوَّاً: قال الحُطيئة: سعيدٌ وما يفعلْ سعيد فإنَّه *** نجيبٌ فَلاَه في الرِّباط نجيبُ وقولهم: فَلوتُه عن أمِّه، أي قطعته عن الفطام، فمعناه ما ذكرناه. وفَلَوْتُ المُهر وافتليتُه. قال: وليس يَهْلك منا سيّدٌ أبداً *** إِلا افتلينا غُلاماً سيِّداً فينا والكلمة الأخرى: فَلَيْتَ الرَّأس أفْليه. ثم يستعار فيقال: فلَيْتَ رأسَه بالسَّيف أفليه. والكلمة الثالثة: الفلاة، وهي المَفَازة، والجمع فلواتٌ* وفَلاً. (فلت) الفاء واللام والتاء كلمةٌ صحيحة تدلُّ على تخلُّصٍ في سرعة. يقال: أفْلَتَ يُفْلِتُ. وكان ذلك الأمر فَلْتَةً، إذا لم يكُنْ عن تدبُّر ولا رأيٍ ولا تردُّد. ويقال: تفلَّتَ إلى هذا الأمر، كأنَّه نازَعَ إليه. وفرسٌ فلَتَانٌ: نشيطٌ حديدُ الفؤاد. وثَوبٌ فَلُوتٌ: لا ينضمُّ طرفاهُ على لابسِهِ من صِغَره، كأنّ معناه أنَّه يُفْلِت من اليد. ومن الباب: افتُلِتَ الإنسان، إذا ماتَ فجأة. وفي الحديث: "أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها". والفَلْتة: آخِرُ يوم من جمادَى الآخرة. (فلج) الفاء واللام والجيم أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدهما على فوزٍ وغَلَبة، والآخر على فُرْجَةٍ بين الشَّيئين المتساويين. فالأول: قولُهم: فُلِجَ الرَّجُل على خَصْمِه، إذا فازَ: والسَّهم الفالِج: الفائز. والرَّجل [الفالج]: الفائز. والاسم الفُلْج. ومن أمثال العرب: "أنا من هذا الأمر فالجُ بن خَلاَوةَ" قالوا: معناه أنا منه بريءٌ. وتفسير هذا أنَّه إذا خلا منه فقد فازَ، أي نجا منه. وخَلاَوة، مِن خلا يخلو. وقال عليٌّ عليه السلام: "إنَّ المرءَ المسلم لم يَغْشَ دناءَةً يَخْشَعُ إذا ذُكِرَتْ له، وتُغْرِي به لئامَ النَّاس، كالياسر الفالج، ينتِظر فَوزةً من قِداحِه". والأصل الآخر: الفَلَج في الأسنان: تَباعُدُ ما بين الثَّنايا والرَّبَاعِيَات. وقال أبو بكر: "رجلٌ أفلج الأسنانِ، وامرأةٌ فلجَاء الأسنان، لابدَّ من ذِكْر الأسنان ". فأمَّا الفَلَج في اليَدينِ فقال أبو عُبيد: الأفلج: الذي اعوجاجُه في يديه، فإنْ كان في رجليه فهو فَحَجٌ. وهذا هو القياسُ الأوَّل؛ لأنَّ اليدَ إذا اعوجَّت فلا بدَّ أن تتجافَى وتتباعد. ومن الباب: الفالِج: الجَمَل ذو السَّنامَين، وسمِّي للفُرجة بينهما. وفرسٌ أفلَجُ: متباعِدُ ما بين الحَرْقَفَتين. وكلُّ شيءٍ شققتَه فقد فَلَجْتَه فَِلْجين، أي نِصفَين. قال ابن دُريد: "وإنِّما قيل فُلِجَ الرّجُل لأنَّه ذهب نِصفُه ". ويقال لِشُقَّة الثَّوب: فَلِيجة: والفَلَج: النَّهر، وسمِّي بذلك لأنّه فُلجَ، أي كأنَّ الماءَ شقَّه شقّاً فصار فُرْجَة. فأمَّا الفَلُّوجة فالأرض المُصْلَحة للزَّرع، والجمع فَلاَليج. وأمَّا الحديث: "أنَّهما فَلَجا الجِزْية"، فإنّه يريد قَسَماها، وسمِّي ذلك فَلْْجاً لأنّه تفريق. (فلح) الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان، أحدهما يدلُّ على شَقٍّ، والآخر على فَوْزٍ وبَقاء. فالأوَّل: فَلَحتُ الأرضَ: شَقَقتُها. والعرب تقول: "الحديد بالحديد يُفْلَح". ولذلك سمِّي الأكّار فَلاَّحا. ويقال للمشقوق الشَّفةِ السُّفلى: أفْلَحُ، وهو بيِّن الفَلَحَة. وكان عنترة العبسيُّ يلقَّب "الفَلْحاء" لفَلَحةٍ كَانت به. قال: وعَنْترةُ الفَلحاءُ جاءَ مُلأَّماً *** كأنَّك فِندٌ من عَمَايةَ أسودُ والأصل الثّاني الفَلاَح: البقاء والفَوْز. وقولُ الرّجُل لامرأته: "استَفلِحي بأمرِك"، معناه فَوزِي بأمرك. والفَلاَح: السَّحُور. قالوا: سمِّي فَلاَحاً لأنَّ الإنسانَ تبقى معه قُوّتُه على الصَّوم. وفي الحديث: "صلَّينا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله حتَّى خفْنا أنْ يَفوتَنا الفَلاَح". قال الشَّاعر: لكلِّ همٍّ من الهُمومِ سَعَهْ *** والمُسْيُ والصّبْحُ لا فَلاَح مَعَهْ (فلذ) الفاء واللام والذال أُصَيلٌ يدلُّ على قَطْع شيءٍ من شيء. من ذلك الفِلْذة: القِطْعة من الكَبِد، والجمع فِلْذ. قال: تكفيه حُزَّةُ فِلْذٍ إنْ ألَمّ بها *** من الشِّواء ويُروي شُربَه الغُمَرُ فالقِطْعة من المال فِلْذةٌ أيضاً. يقال فَلَذْتُ له من مالي، أي قطعت له فِلْذَةً منه. (فلز) الفاء واللام والزاء ليس فيه شيء إلاّ أنّهم يقولون: الفِلِزُّ: خَبَث الحديد يَنْفيه الكِير. (فلس) الفاء واللام والسين كلمة واحدة، وهي الفَلْس، معروف، والجمع فُلوس. ويقولون: أفْلَسَ الرّجل، قالوا: معناه صار ذا فُلوسٍ بعد أن كان ذا دراهم. (فلص) الفاء واللام والصاد ليس فيه شيءٌ، لكنَّهم يقولون: الانفلاص: التفلُّت. وفلَّصت الشَّيء من الشيء خَلّصته. وهذا إن* صحَّ فإنَّما هو من الإبدال، والأصل الميم، يقال مَلَّصَ. وممكنٌ أن يكون الأصل الخاء: خَلَّص. (فلط) الفاء واللام والطاء ليس بأصل، لأنَّه من باب الإبدال، والأصل الراء. ويقولون: أفْلَطَه الأمرُ: فاجَأَه. وتكلَّمَ فلانٌ فِلاطاً، إذا فاجَأَ بقولِهِ. والأصل الراء فرط، وقد ذُكر في بابه. (فلع) الفاء واللام والعين كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على شَقِّ الشَّيء. تقول: فَلَعت الشَّيءَ: شقَقْتُه. وتَفلَّعت البَيضةُ وانْفَلَعَتْ. (فلق) الفاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على فُرْجةٍ وبَيْنُونةٍ في الشيء، وعلى تعظيمِ شيء. من ذلك: فَلَقْتُ الشّيءَ أَفْلِقُه فَلْقاً. والفَلَق: الصُّبح؛ لأنَّ الظَّلام يَنْفلِقُ عنه. والفَلَق: مطمئنٌّ من الأرض كأنَّه انفلَقَ، وجمعه فِلْقانٌ. والفَلق: الخَلْق كله، كأنَّه شيءٌ فُلِق عنه شيء حَتَّى أُبرِزَ وأظْهِر. ويقال: انفَلَقَ الحَجَر وغيرُه وكلَّمنَي فلانٌ من فَِلْق فيه. وهو ذاك القياس. والفَالِق: فضاءٌ بين شَقيقَتيْ رملٍ. وقَوسٌ فِلْقٌ، إذا كانت مشقوقةً ولم تكُ قَضيباً. والفَلِيق كالهَزْمة في جِران البَعير. قال: * فَلِيقُها أجردُ كالرُّمحِ الضَّلِعْ * والأصل الآخَر الفليقة، وهي الدَّاهية العظيمة. والعرب تقول: يا لَلْفليقة. والأمر العَجَبُ العظيم. وأفْلَقَ فلانٌ: أتى بالفِلْق. وكذلك يقال شاعرٌ مُفلِق. وقال سُويد: إذا عَرَضَت داوِيَّةٌ مُدْلهِمَّة *** وغَرَّدَ حاديها عَمِلْنَ بِها فِلْقا والفيلق: العجبُ أيضاً. (فلك) الفاء واللام والكاف أصلٌ صحيح يدلُّ على استدارةٍ في شيء. من ذلك فَلْْكة المِغزل بفتح الفاء، سمِّيت لاستدارتها؛ ولذلك قيل: فَلَّك ثَدْيُ المرأة، إذا استدار. ومن هذا القياس فَلَك السماء. وفلكْتُ الجَدْيَ بقضيبٍ أو هُلْبٍ: أدرتُه على لسانه لئلاّ يرتضع. والفَلَك: قِطَعٌ من الأرض مستديرةٌ مرتفِعة عمَّا حولها. ويقال إنَّ فَلْكة اللِّسان: ما صَلُب من أصله. وأمَّا السفينة فتسمَّى فُلْكا. ويقال إنَّ الواحد والجمعَ في هذا الاسم سواء، ولعلَّها تسمَّى فُلْكاً لأنَّها تدار في الماء.
|